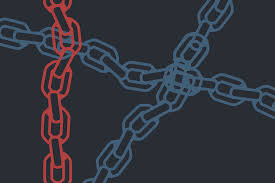الليبرالية في سورية بين الأمس واليوم/ رسلان عامر

مقدمة:
تنبع أهمية الليبرالية من ارتباطها الوثيق بقضية الحرية التي ترتبط بدورها ارتباطًا جوهريًا بإنسانية الإنسان، وترتبط بالدرجة نفسها بالديمقراطية التي يفترض أنها النظام النقيض للاستبداد والظلم، ما يجعلها من ثم النظام الإنساني الصالح الذي يجب أن تتحقق فيه الحرية الإنسانية والحقوق الإنسانية وتحمى.
وبذلك تلتقي الديمقراطية والليبرالية في الغاية الإنسانية وفي قضية الحرية.
واليوم في سورية أصبحت الديمقراطية هدفًا تتبناه القوى الوطنية السورية كلها؛ الساعية إلى بناء الدولة الوطنية السورية الحديثة، وهذا ما يجعل مسألة الليبرالية ملحة للطرح في موقعها من هذه الديمقراطية المتبناة وعلاقتها بها.
وهذا ما يتناوله هذا البحث الذي يدور حول مسألة العلاقة بين الديمقراطية والليبرالية، ووضع الليبرالية في الساحة السورية وإمكانيتها وضرورتها.
واقع الحال الراهن:
لأول وهلة قد يثير الحديث عن الليبرالية في سورية الراهنة ردة فعل سلبية، وقد يبدو أن هذا الحديث عن مسألة قليلة الأهمية، ويمكن عدّها غير ضرورية في المجتمع السوري من ناحية، ولا فرصة لها فيه بالنمو والانتشار من ناحية ثانية، والأمران مرتبطان جدليًا.
وهذا ليس غريبًا اليوم بسبب هيمنة الاستبداد وتفشي الفساد وتدني مستوى الثقافة العام في الواقع السوري الراهن.
عدا عن ذلك، فالقوى السياسية الموجودة في الساحة السورية اليوم، حتى وإن كان لديها استقلالها الخاص، ولم تكن تابعة أو خاضعة لمنظومة الاستبداد والفساد المسيطرة، فالعديد منها ليس له موقف إيجابي من الليبرالية، ولا سيما القوى ذات الطابع التقليدي.
فبالنسبة إلى قوى الإسلام السياسي وسواها من القوى المحافظة عمومًا، تعد الليبرالية ثقافة غربية أجنبية، وفي نظرها يعد طرحها في المجتمع السوري المتدين المحافظ استيرادًا لثقافة غريبة تتناقض في كثير من الجوانب الخطرة والحساسة مع تقاليد هذا المجتمع، بل يمكن من وجهة نظر هذه القوى أيضًا عدّ هذا الطرح شكلًا من أشكال الغزو الثقافي الخطر على دين المجتمع السوري وأخلاقه.
أما القوى العروبية فلديها هي الأخرى بدورها موقف مشابه، وهي أيضًا ترى الليبرالية ثقافة أجنبية، والترويج لها ونشرها يعد أمرًا خطرًا على الثقافة العربية الأصيلة، ومن ثم على القومية والهوية العربية بحد ذاتيهما وفقا لهذه القوى.
وبالنسبة إلى القوى اليسارية، تقترن صورة الليبرالية عادة بالرأسمالية، ولا سيما الليبرالية الاقتصادية التي تجد فيها الرأسمالية حاضنتها الفكرية وتبريرها الأيديولوجي، ولذا ترفض هذه القوى الليبرالية، بل تضعها في الخندق الخصم.
وهكذا قد يبدو أن الليبرالية في المجتمع السوري ليس لديها من حظوظ ولا من دواع حقيقية، ولذلك لا يجب إيلاؤها أي اهتمام إيجابي إن لم يكن العكس.
مع ذلك فالأمر قطعًا ليس كذلك، لا من ناحية إمكانية الليبرالية، ولا من ناحية ضرورتها بالنسبة إلى المستقبل السوري، بل إن الأمر لم يكن قطعًا كذلك حتى في الماضي السوري الحديث القريب في مرحلة ما بعد الاستقلال، حيث كان لليبرالية حضور واقعي فاعل في التجربة السورية السياسية، وكانت الشخصيات الوطنية الليبرالية هي من يقود سورية إن لم تقاطعها الانقلابات العسكرية، وتلك كانت مرحلة ازدهار رائدة في التاريخ السوري الحديث ومتميزة في الساحة العربية وحتى في مستوى دول العالم الثالث في حينها.
ما هي الليبرالية وما هي العلاقة بينها وبين الديمقراطية؟
في قاموس المورد القريب الإنكليزي- العربي نجد لكلمة (ليبرالية) liberalism)) الإنكليزية مقابلًا عربيا هو (تحررية)([1]).
وفي الفكر الفلسفي الليبرالي تعد الحرية الإنسانية حقًا ملازمًا لإنسانية الإنسان وقائمًا عليها، فوفقًا للفيلسوف الإنكليزي جون لوك (John Locke) الذي يُعدّ الأب الروحي لليبرالية([2])، البشر “موجودون بشكل طبيعي في حالة من الحرية الكاملة… لترتيب أفعالهم على النحو الذي يعتقدون أنه مناسب… دون طلب إذن، أو اعتماد على إرادة أي شخص آخر”([3])، وهذه قضية لا تحتاج إلى إثبات، أما الفيلسوف والاقتصادي الإنكليزي جون ستيوارت ميل (John Stuart Mill)، فيؤكد أن “عبء الإثبات من المفترض أن يقع على عاتق أولئك الذين يعارضون الحرية الذين ينادون بأي تقييد أو حظر… الافتراض المسبق هو لصالح الحرية”([4])،وخلاصة هذه الفكرة التي يمكن عدّها (المبدأ الذي تقوم عليه الليبرالية) تتطابق مع الكلمة العظيمة التي سبق أن قالها عمر بن الخطاب “متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟”.
من ثم يمكن القول إن (الليبرالية هي مذهب الحرية) أو (مذهب التحرر)، وأنها المذهب الفكري والعملي الذي يرى أن الحرية هي حق طبيعي للإنسان بوصفه إنسانًا، ويسعى إلى ترجمة ذلك في حياة الإنسان في المجتمع بحيث يحيا الإنسان حياته حرًا، وهذا ما يترتب عليه الاعتراف للإنسان بالحرية وضمانها على الصعد كافة، الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والعقائدية وسواها.
فإن كانت هذه هي الليبرالية، فما هي العلاقة بينها وبين الديمقراطية؟
في فهمنا المعاصر نضع الديمقراطية نقيضًا وبديلًا في مواجهة أنظمة الدكتاتورية والاستبداد وأشكال القمع والتسلط كلها، وبذلك تصبح الديمقراطية مقترنة بالحرية، وتلتقي التقاء جوهريًا ووثيقًا بالليبرالية.
وعليه لا يمكن فعليًا الفصل بين الديمقراطية والليبرالية الحقيقيتين، وأي طرح من هذا القبيل هو باطل، فأي ديمقراطية غير ليبرالية، ستكون عمليًا ديمقراطية من دون حرية، أو منقوصة الحرية، وستتشابه مع أشكال القمع والتسلط الأخرى، وبفرض أن مثل هذه الديمقراطية ممكنة، وهي فعليًا تضع السلطة بيد الشعب، فعندها لن تكون (سلطة الشعب) هذه سوى (دكتاتورية جماعة ضد الفرد) أو (دكتاتورية أغلبية ضد الأقلية أو الأقليات) أو (حكم للدهماء)، وستكون فعليًا سلطة فاقدة للجوهر الإنساني؛ وبالمقابل أي ليبرالية من دون ديمقراطية، أي من دون أن تكون السلطة بيد الشعب، ستكون ليبرالية تحت سلطة فرد أو مجموعة من الأفراد، بحيث يتمكن هذا الفرد أو المجموعة من الاستئثار بالسلطة، والتحكم في الدولة والمجتمع، وعندها سيكون نطاق الحرية مرهونًا تمامًا بإرادة هذا الفرد الحاكم أو هذه المجموعة الحاكمة، ولن يكون لدى الشعب أو الفرد أي ضمانات لحرياتهما أو آليات للدفاع عنها، وستصبح هذه الحريات هشة، وشكلية في جوانب عدة، فمن لا يملك القرار لا يمكنه فعلًا أن يكون حرًا، وستكون حريته منة عليه من غيره لا أكثر في أي درجة من درجات وجودها.
في الغرب الحديث الذي يعد المعقل الرئيس لكل من الديمقراطية والليبرالية، فعليًا لا تنفصل الديمقراطية والليبرالية عن بعضهما، وتشكلان وحدة متكاملة تسمى (الديمقراطية الليبرالية)، وعن هذا يقول أستاذ العلوم السياسية الأميركي – الألماني ياشا مونك (Yascha Mounk): “تتميز النظم السياسية في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية بمكونين أساسيين. فهي في نفس الوقت ليبرالية لأنها تسعى إلى ضمان حقوق الأفراد، بما فيها حقوق الأقليات المهمشة، وأيضًا ديمقراطية لأن مؤسساتها تقوم بترجمة وجهات النظر الشعبية اٍلى السياسة العامة“([5]).
لكن هذه الوحدة تتعرض اليوم لتحديات خطرة كالشعبوية (Populism) التي تمكنت من إيصال ترامب إلى رئاسة أميركا وأخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتواجه انتقادات شديدة وتطرح فيها أحيانًا بدائل مختلفة لها كالتكنوقراطية أو الأبستقراطية وسواهما، ويطرح في بعض الأحيان حتى في بعض الدول المتقدمة فكرة (الديمقراطية غير الليبرالية) أو (الليبرالية غير الديمقراطية).
والسبب الرئيس في ذلك كله هو تراجع مستويات المعيشة في البلدان الغربية المتقدمة، في وقت تعتمد فيه الحكومات في قرارها أكثر فأكثر على النخب المختصة، فيأتي القرار في كثير من الأحيان غير متوافق مع إرادة عامة الشعب ومصلحته، ويدفعها بذلك إلى ردات فعل سلبية ضد المنظومة الديمقراطية الليبرالية القائمة التي تشعرها بالخذلان والاستلاب، وعندها تصبح الشعبوية بديلًا، وهذا الحال في واقع الأمر لا يرتبط بخلل أو فشل ذاتيين في الديمقراطية أو الليبرالية بحد ذاتيهما، ولكنه يرتبط جوهريًا بطبيعة الرأسمالية المهيمنة في الغرب التي تمكنت من الهيمنة حتى على الديمقراطية والليبرالية فيه وتسخيرهما لمصلحتها.
إمكانية الليبرالية في سورية:
شهدت سورية تجربة ليبرالية -بالمفهوم الموسع للليبرالية الذي تندمج فيه مع الديمقراطية- إيجابية واعدة في مرحلة ما بعد الاستقلال، وتلك التجربة كانت ذات بعدين.
البعد الأول هو بعدها العام، أي البعد الذي توجد فيه الليبرالية في مستوى الديمقراطية متكاملة مع هذه الديمقراطية.
أما البعد الثاني فهو البعد الخاص الذي توجد فيه قوى ليبرالية محددة تتبنى الليبرالية كعقيدة حزبية أو برنامج سياسي.
ويعود النجاح في تلك المرحلة في البعدين كليهما إلى سبب واحد، وهو حالة النهوض العامة التي كان يشهدها المجتمع السوري، المقترنة بوجود رافعة وطنية تقدمية، بالمعنى الواسع للتقدم، مرتبطة بدورها بالسعي إلى بناء الدولة الحديثة والإيمان القوي بإمكانية نجاح هذا السعي، وهذا ما كان يعززه الانتصار الوطني الكبير المنجز، المتمثل في تحقيق استقلال البلاد وتحريرها من الاستعمار.
من الإنجازات المميزة للتجربة الديمقراطية الليبرالية في سورية في مرحلة ما بعد الاستقلال، أنها كانت تسير بشكل إيجابي على خطا الديمقراطيات الحديثة من حيث احترام الدستور، والتعددية السياسية، ونزاهة الانتخابات، وتداول السلطة، واستقلال الإعلام، وحرية التعبير والاعتقاد والتنظيم، واحترام حقوق الناس، وفي الانتخابات البرلمانية التي جرت أكثر من مرة، شهدت النتائج تنوعًا يدل على أن الحياة السياسية في سورية في تلك المرحلة كانت نشيطة وصحية، ففي انتخابات 1954 البرلمانية مثلًا حصل حزب الشعب على 30 مقعدًا، وحزب البعث على 22 مقعدًا، والحزب الوطني على 19 مقعدًا، والإخوان المسلمون على 4 مقاعد، وحزب التعاون على مقعدين، والحزب السوري القومي على مقعدين، والحزب الشيوعي على مقعد، والمستقلون على 60 مقعدًا([6]).
وكان حزب الشعب والحزب الوطني حزبين لبيراليين، ينتميان إلى تيار الليبرالية المحافظة (Conservative liberalism)، وقد أسس حزب الشعب ناظم القدسي ورشيد كيخيا، فيما أسس الكتلة الوطنية هاشم الأتاسي وشكري القوتلي، وهؤلاء جميعًا كانوا شخصيات وطنية تحظى باحترام كبير في الساحة السورية([7])([8]).
لكن تلك التجربة بأبعادها كافة تلقت ضربة قوية على يد دولة الوحدة التي قامت في 1958، ثم قضى عليها انقلاب البعث في 1963، وبقيت الحياة السياسية مشلولة عمليًا في سورية حتى انطلاقة الانتفاضة السورية في2011، وعلى الرغم من أن بعض القوى السياسية من توجهات مختلفة استمرت أو نشأت في الخارج، إلا أنها كانت قوى ضعيفة، ومعظهما تقريبًا لم يكن له تأثير ونفوذ في الداخل السوري، أما القوى التي وجدت أو نشأت في الداخل، فكان عليها أن تختار بين التبعية والخضوع للنظام الحاكم المستبد، أو مواجه القمع والملاحقة.
تمكنت انتفاضة 2011 من أن تكون مفصلًا في التاريخ والحياة السورية الراهنة على الرغم من المسار المأساوي كله الذي دفعت فيه، وأعادت بعض النشاط والحيوية إلى الحركة السياسية، وشكل عدد من الأحزاب والتنظيمات المختلفة، ومن بينها أحزاب وكتل ليبرالية مثل (كتلة الليبراليين المستقلين، الحزب السوري الليبرالي الديمقراطي، الحزب الليبرالي المستقل، الحزب الوطني السوري، حزب أحرار – الحزب الليبرالي السوري، الحزب العلماني الديمقراطي الليبرالي السوري – حزب عدل)، وغيرها، وقبل بداية الانتفاضة كان هناك شخصيات ليبرالية بارزة ومعروفة مثل برهان غليون ورياض سيف وكمال اللبواني ونبيل فياض والياس الحلياني وجهاد نصرة وغيرهم، وظهرت شخصيات أخرى بعد انطلاقة الانتفاضة منها ياسمين مرعي رئيسة حزب أحرار([9])، ومنيف العبد الله رئيس الحزب السوري الليبرالي الديمقراطي([10])، على سبيل المثال.
وهذه القوى نفسها لديها مقاربات ليبرالية مختلفة، لكن هذه كلها؛ القوى وغيرها من القوى السياسية الراهنة تعمل اليوم في ظروف مختلفة كثيرًا عن الظروف التي كانت تعمل فيها قوى ما بعد الاستقلال، فتلك القوى كانت تعمل في أجواء من الشعور الوطني بالنصر والتحرير والإيمان بمستقبل البلد، وكان لها دور رئيس في قيادة البلاد التي كانت تسير على طريق التطور، أما قوى اليوم فهي تعمل وسط كارثة جسيمة، فالبلاد تعرضت إلى دمار كبير، وتقاسمت السيطرة عليها القوى الخارجية التي بلغت تدخلاتها أقصى وأبشع الحدود، والاستبداد لم ينته بعد، وهو يحاول إعادة إنتاج نفسه، والفساد مستشر إلى حد كبير سواء في مناطق سيطرة النظام، أم في ما تبقى من مناطق سيطرة المعارضة وحتى في أوساط المعارضة الخارجية، وهذا كله يؤثر في القوى السياسية السورية الراهنة بكافة اختلافاتها ويطبعها بطابعه إلى حد كبير، ولذا نراها ضعيفة ومشتتة وغالبًا تابعة في الخارج أو في الداخل لداعميها الخارجين، أو تعمل في الداخل تحت هيمنة النظام وبشروطه أو تحت ملاحقته وعنفه.
وبالطبع مستقبل هذه القوى كلها وغيرها من القوى رهن بمستقبل الحل السوري الذي يبدأ بالخلاص من الدكتاتورية، وهو حل تشكل فيه القوى السورية الرافضة لهذه الدكتاتورية الطرف الأضعف، أما الأطراف الأقوى فهي التدخلات الخارجية التي تبحث عن حلولها الخاصة.
مع ذلك ليس أمام السوريين سوى مواصلة النضال للخلاص من الدكتاتورية والهيمنات الأجنبية وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة، وهذا ما يقتضي الوضوح في رؤية هذه الدولة، وكيف يجب أن تكون، ومن المهم جدًا في هذا إيلاء الليبرالية الأهمية الكافية.
ضرورة الليبرالية في سورية:
بناء على توضيح العلاقة بين الديمقراطية والليبرالية، وما وُضح في خلاصة ذلك من تلازم وتكامل بينهما، يمكن القول إن الليبرالية بمفهومها العام في سورية ضرورية تمامًا من أجل الوصول إلى ديمقراطية حقيقية تحترم فيها إنسانية الإنسان وحرياته وحقوقه، فالبعد الليبرالي في الديمقراطية هو بعد جوهري لأنسنة مبدأ (حكم الشعب) الذي تقوم عليه الديمقراطية، وهو الفيصل الرئيس بين أن تكون الديمقراطية نظامًا تتحقق فيه الحرية وتحمى أو تتحول إلى دكتاتورية جماعة أو دكتاتورية أغلبية أو شبه ديمقراطية في أحسن الأحوال، وهو يلعب دورًا مهمًا أيضًا في منع تحول الديمقراطية إلى شعبوية أو حكم دهماء أو ديمقراطية طبقية تخدم مصلحة الطبقة الأقوى أو الفرقة الأقوى في المجتمع، وبذلك يكون للليبرالية دور فاعل لا غنى عنه في مسألتي العدالة الاجتماعية والكفاءة السياسية اللتين لا تنفصلان عن حريات الإنسان وحقوقه، فضمان حقوق الإنسان في جوانب متعددة منه يرتبط بوجود العدالة الاجتماعية وكفاءة القيادة السياسية، والحرية المتاحة في المجتمع والدولة هي شرط أساسي لازم للعمل من أجل تحقيق هذه وتلك.
ولذا يجب توخي الحذر الكافي من خطر أي طرح أو فهم للديمقراطية لا يراعي أهمية الليبرالية فيها، و(الديمقراطية الانتخابية) التي تختزل فيها الديمقراطية من قبل بعض القوى، من الإسلام السياسي وسواه، هي فعليًا ديمقراطية غير ليبرالية، وهي في أحسن أحوالها شبه ديمقراطية إن لم تكن ديمقراطية زائفة.
أما في ما يتعلق بالاعتراضات التي توجه ضد الليبرالية وبشكل رئيس على الصعيدين الأخلاقي والاقتصادي، فيمكن الرد عليها بأن الليبرالية ليس لديها نموذج أخلاقي محدد يجب فرضه في المجتمعات كلها، وهي باعترافها بحريات الإنسان وحقوقه تعترف تمامًا بالاختلافات الثقافية وبحق الثقافات المختلفة بالوجود والنشاط ولا تسعى إلى إلغائها واستبدالها والدليل البسيط على ذلك هو أن المجتمعات الغربية المعاصرة فيها كثير من الثقافات الوافدة ومن بينها الإسلام، ففي فرنسا وحدها، وفقا لبيانات (مركز بيو للأبحاث) (PEW Research Center) بلغ عدد المسلمين حتى 2016 5.7 مليون شخص، أي ما يعادل 8,8% من مجمل السكان([11])، وهي -أي المجتمعات الغربية- تعطي للمسلمين في الغرب إمكانية الحفاظ على إسلامهم ولا تفرض عليهم أي نمط ثقافي أو اجتماعي آخر.
وفيما يخص القومية والدين، فالليبرالية قطعًا ليست ضد أي منهما، وهي بالعكس تركز على حماية حرية المعتقد والتنوع الاجتماعي والثقافي، وهذا ما يثبته واقع الحال في الدول الليبرالية المعاصرة، والليبرالية فقط ضد التعصب والتطرف واللاعقلانية سواء في الدين أم القومية، ولن يجادل عاقل في كونها محقة تمامًا في ذلك.
أما بالنسبة إلى العلاقة بين الليبرالية والرأسمالية، وهذه مسألة شديدة الأهمية لما لها من تأثير في قضية العدالة الاجتماعية، وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فالليبرالية أيضًا ليست مذهبًا واحدًا في هذا الشأن.
فهناك المذهب النيوليبرالي (Neoliberalism) الذي يعد الاقتصاديان الأميركي ميلتون فريدمان (Milton Friedman)([12]) والنمساوي فريدريش أوغوست فون هايك (Friedrich August von Hayek)([13]) من أعمدته، وهو مذهب يقوم على فكرة تحرير الأسواق ومنع تدخل الدولة فيها، ويرفض أي دور للدولة في الاقتصاد كما يرفض أن تضمن الدولة الرعاية الاجتماعية في المجتمع، وهو يرى دولة الرعاية الاجتماعية عائقًا أمام النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي اللذين يرتبطان فعليًا بحرية السوق بموجب هذا المذهب، وهذا المذهب هو من تسبب بفلتان السوق، وتضخم التفاوت الطبقي وتدني مستوى المعيشة، وأزمة عام 2007 العالمية هي أحد أبرز نتائجه.
مقابل هذا المذهب هناك المذهب الأوردوليبرالي (Ordoliberalism) الذي يعود الفضل في تطويره إلى الاقتصاديين الألمانيين فالتر أويكن (Walter Eucken) وألكسندر روستوف (Alexander Rüstow)، وهو يعطي للدولة الحق في ضبط عمل السوق من دون التدخل المباشر في هذا العمل، ويركز على أهمية الدور الرعائي الاجتماعي للدولة، وأهمية العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، وهذا المذهب هو القاعدة الرئيسة الذي يقوم عليها (اقتصاد السوق الاجتماعي)([14]) الذي تمكن من تحقيق المعجزة الاقتصادية في ألمانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية بقيادة لودفيغ ايرهارد (Ludwig Erhard).
وهناك أيضا الاقتصاد الكينزي (Keynesian economics)، الذي وضع أسسه الاقتصادي الإنكليزي جون مينارد كينز (John Maynard Keynes) الذي يركز على وجود دولة قوية، وينيط بها دورًا اقتصاديًا مهمًا لمواجهة الكساد في الأزمات عبر تعزيز الطلب في الأسواق عن طريق دعم دخل المستهلكين([15]).
وكما نرى فالأردوليبرالية والكينزية توليان اهتمامًا كبيرًا للمسألة الاجتماعية وتريانها من مهمات الدولة الأساسية، ومثل هذا الخط في الليبرالية يسمى بــ(الليبرالية الاجتماعية)، ولكن الأمر لا ينتهي هنا، فهناك أيضا (الاشتراكية الليبرالية) (Liberal socialism) التي تقوم على فكرة الجمع بين حسنات كل من الاشتراكية والليبرالية، ومن أشهر أعلامها الفيلسوف والاقتصادي الإنكليزي جون ستيوارت ميل.
ما يعني في الحصيلة أن الربط بين الليبرالية وصورة (الرأسمالية المتوحشة) هو ربط تعسفي وسطحي، ولدى الليبرالية الكثير لتقدمه في مسألة العدالة الاجتماعية التي لا يتناقض معها (مبدأ الليبرالية في حرية الإنسان) من حيث هو مبدأ، وإن كان ممكنًا لذلك التناقض أن يحدث نتيجة مفعولات بعض أشكال الفهم لهذا المبدأ، كربط مفهوم الحرية الاقتصادية بالرأسمالية.
ويجدر الذكر في هذا السياق، أن أحد عيوب ديمقراطية الخمسينيات الرئيسة في سورية كان في عدم إيلائها الأهمية الكافية للبعد الاجتماعي، والقوى الليبرالية التي كان لها دور سياسي قوي فيها تركزت في بورجوازية المدن، وركزت اهتمامها على مصالح هذه البورجوازية، وهذا ما أبعدها عن الشرائح الفقيرة الواسعة في الأرياف والأحياء الشعبية التي تمكن حزب البعث من مد نفوذه فيها بما لديه من توجهات يسارية في حينها، وهذا خطأ لا يجوز تكراره.
بين الأمس واليوم:
إذا ما تأملنا في التجربة السياسية السورية في مرحلة ما بعد الاستقلال ككل، فسنجد أنها كانت تجربة متميزة متكاملة، سواء في مستوى القوى الليبرالية التي كانت تعمل فيها، أو في مستوى نظام عملها كمنظومة ديمقراطية كلية تشكل ليبراليتها ركنًا جوهريًا من ديمقراطيتها، فقد تميزت تلك التجربة في سورية بأنها كانت فعليًا تضاهي التجارب المتقدمة من حيث مبادئ عملها وآلياته، المتمثلة في احترام قوانين ومؤسسات الدولة، والتداول السلمي للسلطة وجريان الانتخابات بشكل نزيه، واحترام التعدد والاختلاف، وضمان الحريات المدنية والحقوق العامة والخاصة واستقلال الإعلام، وتميزت هذه التجربة في سورية بغناها من حيث التنوع السياسي، ووجود عدد من القوى السياسية المختلفة الفاعلة والناشطة فيها، وعدم وجود هيمنة لطرف محدد فيها، أما القوى الليبرالية المتمثلة في الأحزاب الليبرالية المنظمة كحزب الشعب والحزب الوطني أو بالشخصيات الليبرالية المستقلة، فقد كان لها دور طليعي في هذه التجربة، وقد كان الليبراليون الحزبيون والمستقلون هم فعليًا من يقودون سورية في مستوى رئاسة الجمهورية أو مستوى رئاسة الوزراء، وكانوا شخصيات وطنية حقيقية تحظى باحترام كبير في الأوساط الشعبية، وكان من هؤلاء شكري القوتلي وهاشم الأتاسي وناظم القدسي ورشيد كيخيا وفارس الخوري وخالد العظم وسعيد الغزي وحسن الحكيم وسواهم ممن لعبوا أدوارًا مهمة في العمل على تحرير سورية من الاستعمار الفرنسي، وفي تأسيس جمهورية ما بعد الاستقلال الحديثة في سورية وبنائها، وقد تميزت هذه القوى الليبرالية المنظمة أو المستقلة في سورية بأنها قوى وطنية داخلية ومستقلة ومرتبطة بالمجتمع السوري وقضاياه، وكان لها حاملها الاجتماعي الخاص المتمثل بشكل رئيس بالبرجوازية الوطنية، وهذه القوى على الرغم من ليبراليتها تمكنت من التوفيق بين الفكر الليبرالي من ناحية والدين والثقافة العربية في المجتمع السوري، ولم تكن ليبراليتها تشكل حالة تناقض أو تنافر مع التقاليد الدينية والثقافية السائدة في المجتمع السوري، مع أنها كانت قوى تحديثية وتطويرية ولم تكن في حالة انصياع واستلاب لما في هذا المجتمع من مواريث سلبية.
وبالطبع الفضل الأكبر في تلك التجربة كلها في مستوييها العام والخاص كان للحالة الوطنية العالية التي كان يحياها المجتمع السوري في مرحلة ما بعد الاستقلال التي كانت فيها كل الأحلام الوطنية والديمقراطية والقومية والاشتراكية واقعية في إطار المشروع الأكبر المتمثل في بناء الدولة الحديثة.
لكن بالطبع ككل تجربة كان لتلك التجربة ثغراتها الذاتية، ومن أهمها أن القوى الليبرالية كانت متمركزة بشكل رئيس في بورجوازية المدن الكبرى ولا سيما دمشق وحلب، ولم تولِ هذه القوى الاهتمام الكافي للمسألة الاجتماعية ولحاجات الطبقات الفقيرة في الأرياف والمدن الصغرى والأحياء الشعبية، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى عدد من القوى السياسية التي شاركت في اللعبة الديمقراطية هي نفسها لم تكن ديمقراطية ولا ليبرالية، وكانت هذه اللعبة بالنسبة إليها تكتيكية أكثر منها استراتيجية، وهذا كان حال القوى القومية واليسارية والإسلامية التي كان لديها مشروعاتها الخاصة غير الديمقراطية كالمشروع العروبي أو الاشتراكي أو الإسلامي، المرتبطة بشكل جوهري بنموذج دولة الحزب الواحد، ولذا انقلب (حزب البعث) على الديمقراطية العائدة بعد سقوط دولة الوحدة في سورية عندما أتيحت له الفرصة، ومن ناحية ثالثة.. التجربة الديمقراطية الليبرالية في تلك الآونة كانت ما تزال غضة العود في مستواها كتجربة سياسية أو في مستوى خلفيتها الاجتماعية، حيث كان المجتمع السوري ما يزال حديث العهد في تجربته الديمقراطية التي لم تتجذر وتُحسم بعد وتصل إلى شط الأمان.
مع ذلك فتلك الثغرات كلها لم تكن قاتلة وكان تجاوزها وتصحيحها ممكنين في التجربة الديمقراطية السورية التي لم تفشل وإنما أُفشلت، وقد لعبت في ذلك الظروف الخارجية الدور الرئيس، وكان لنشوء الكيان الصهيوني وانقسام العالم إلى معسكرين متصارعين الدورين الأكبر في ذلك، فهما قد أنتجا من الأخطار والتهديدات الخارجية، ما جعل مسألة الأمن الوطني والقومي تتصدر المشهد السياسي في سورية وتعلو على الاستحقاقات الأخرى كلها، وبذلك تراجعت أهمية الديمقراطية إلى مرتبة ثانوية، وتمكن العسكر والقوى غير الديمقراطية من الاستيلاء على السلطة بذريعة حماية الوطن التي أعطيت فيها الوطنية مفهومًا مختزلًا يركز على التصدي المزعوم للاعتداءات والأخطار الخارجية، وهُمشت وأهملت فيها الاستحقاقات الداخلية، وهذا المفهوم الفاسد للوطنية نما لاحقًا وتضخم واستمر حتى اليوم، وقد حدث بهذا بفعل الاستبداد والفساد المسيطرين اللذين من مصلحتهما تكريس مثل هذا النمط من الوطنية أو الوطنجية واستغلاله.
أما اليوم، فواقع حال القوى الديمقراطية عمومًا واللليبرالية خصوصًا مختلف جدًا في الساحة السورية التي تفتقد إلى تلك الأجواء الوطنية العالية المستوى كما كان الحال في مرحلة الخمسينيات، وعلى الرغم من عقود الاستبداد والإفساد وإفقار البلاد على الصعد كافة؛ اجتماعيًا واقتصاديًا وثقافيًا وسياسيًا وعلميًا وأخلاقيًا، تمكن الشعب السوري من القيام بانتفاضته من أجل الديمقراطية في 2011، إلا أن تلك الانتفاضة كانت حركة شعبية بل وشعبوية عفوية وتفتقر إلى معظم إمكانات العمل المنظم، وهذا بدوره يعود إلى طول وطأة مرحلة الاستبداد وشدة قسوتها، وقد كانت هذه الانتفاضة أيضًا محاصرة بقوى داخلية وإقليمية ودولية عاتية، فحرفها ذلك كله عن مسارها الوطني ودفعها إلى العسكرة، ووظفها في لعبة تصفية حسابات المصالح والأطماع الدولية والإقليمية، وأدى ذلك إلى صراع عنيف لم ينته بعد أن أدى بدوره إلى تقسيم البلاد وألحق بها أضرارًا هائلة على الصعد كافة.
وهكذا تجد القوى السياسية الديمقراطية السورية، الليبرالية وغير الليبرالية، نفسها اليوم مضطرة إلى العمل في مثل هذه الأجواء الكارثية من التقسيم والسيطرة الأجنبية والدمار والنزيف البشري والاقتصادي والتدهور المعيشي والإحباط العام وغياب أفق الحل والخلاص على المدى المنظور، وذلك يعني أنه لا يمكن قطعًا استعادة تجربة الخمسينيات أو إحياؤها بسبب الاختلاف الجذري الهائل في الظروف.
معظم القوى السياسية اليوم سواء في الداخل السوري، في منطقة سيطرة النظام أم ما تبقى من مناطق سيطرة المعارضة، أم في الخارج السوري، هي عمومًا من دون حوامل اجتماعية وشعبية، والعلاقة بينها وبين الجماهير شبه مقطوعة، وهي تعمل بشكل نخبوي منعزل وفي ظروف افتقار أو انعدام للاستقلالية في معظم الأحيان، فالقوى التي تعمل علنًا في الداخل هي مضطرة إلى العمل بشروط النظام الحاكم في منطقة سيطرته، وهي شروط شديدة الوطأة وتحول العمل السياسي إلى عمل هامشي عقيم، وإن لم تكن القوى السياسية في الداخل مرخصة برخصة النظام المزعومة فسيكون عليها أن تعمل تحت أخطار ملاحقته وبطشه، والحال لا يختلف كثيرًا في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة، أما في الخارج فغالبًا ما تكون القوى السياسية مضطرة إلى العمل بشكل يرضي حاضنيها وداعميها الخارجيين ويوافق إراداتهم، وليس وفق إرادتها وما يناسب الحاجة السورية، وعدا عن ذلك كله فالساحة الشعبية اليوم بسبب استمرار مفعولات عقود الاستبداد والإفساد التي لم تنته بعد، وبسبب الدمار والتدهور المعيشي، هي اليوم غالبًا في حالة مستفحلة من اللامبالاة والعزوف عن النشاط السياسي، وفقدان الثقة بجدوى هذا العمل، وهذا ما يضاعف حجم المصاعب والعقبات التي تعرقل عمل القوى الديمقراطية في سورية.
مع ذلك.. وعلى الرغم من تلك الحيثيات السلبية الجسيمة كلها، فقد تمكنت الانتفاضة السورية من إحداث متغير إيجابي كبير، يتمثل في إطلاقها عجلة التغيير وتحريكها حتى الآن، ويبدو واضحًا أن إيقافها وإعادتها إلى حالة السكون بات مستحيلًا، فقد تلاشت حالة الثبات والركود التي كانت الدكتاتورية تنعم فيها وتزعزعت معها أركان هذه الدكتاتورية نفسها واتضح فعليًا كم هي هشة ورخوة وغير قادرة على الاستمرار.
وعلى الرغم من الاختلافات الكبيرة بين الوضع السوري الراهن والوضع السوري في مرحلة الاستقلال، فثمة أمر يتشابه فيه الوضعان، فنشاط القوى السياسية في مرحلة الاستقلال انقسم بدوره إلى مرحلتين، الأولى تضمنت العمل على تحقيق الاستقلال، وهذا ما اجتمعت عليه واشتركت فيه القوى الوطنية كلها في حينها، والثانية تلتها بعد تحقيقه، وهي مرحلة العمل على بناء الدولة السورية الحديثة، وفيها اختلفت هذه القوى، واتبع كل منها الأسلوب الذي يراه مناسبًا في إطار وطني ديمقراطي عام، واليوم على القوى الوطنية كلها أن توحد جهدها للخلاص من الاستبداد الداخلي والتدخل الخارجي، وهذه مرحلة، وبعد أن يتحقق ذلك، تبدأ مرحلة إعادة بناء الدولة السورية الحديثة التي يمكن فيها للقوى السياسية الوطنية أن تختلف في رؤاها للديمقراطية والليبرالية وسواهما، وسبل تحقيقهما، لكن ذلك لا يعني إرجاء امتلاك الرؤية الواضحة إلى إشعار آخر، والمطلوب بلورة هذه الرؤية بشكل جلي منذ اليوم.
خلاصة:
في الخلاصة يمكن القول إن الديمقراطية التي يتفق عليها اليوم كل من يريدون بناء الدولة الوطنية، الحديثة والعصرية في سورية، تقتضي رسم صورة واضحة للديمقراطية، وموقع الحريات وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في هذه الديمقراطية، وهنا يمكننا القول إننا نحتاج إلى (ديمقراطية ليبرالية) حقيقية، ولكن ليس من النوع (النيوليبرالي) الذي أوقع حتى مجتمعاته المتقدمة في مآزق وجعلها ساحة مناسبة لنمو الشعبوية والتطرف اليميني، بل ليبرالية من النموذج الذي يولي الأهمية الكافية لحريات الإنسان وحقوقه، ويعطي المسألة الاجتماعية الاقتصادية حقها من الاهتمام، ولذلك يجب التركيز على ديمقراطية سورية ذات بعد اجتماعي يركز بدوره على نموذجي الليبرالية الاجتماعية أو الاشتراكية الليبرالية وفق منظور سوري ينطلق من حيثيات الواقع السوري وخصوصياته، ويستفيد من التجربة السورية السابقة ومن تجارب الآخرين من دون أن يكررها أو يستوردها.
فالديمقراطية الحقيقية لا يمكن فصلها عن الليبرالية التي تعني ضمان الحريات والحقوق الإنسانية، وهذا لا يتحقق إلا في ليبرالية اجتماعية تولي القضايا الاجتماعية الاهتمام الكافي، ومن ثم تكون الديمقراطية المطلوبة في سورية هي ديمقراطية ليبرالية اجتماعية، لا نقص في ليبراليتها ولا في اجتماعيتها.
[1] – منير البعلبكي، “المورد القريب قاموس، جيب إنكليزي-عربي”، دار العالم للملايين، لبنان، 1998، ص 231.
[2] – يمنى طريف الخولي، ركائز في فلسفة السياسة، مؤسسة هنداوي، عام ٢٠١٩
[3] – Liberalism (Stanford Encyclopedia of Philosophy)
[4] – Liberalism (Stanford Encyclopedia of Philosophy)
[5] – ياشا مونك، الديمقراطية الغير ليبرالية أو الليبرالية الغير ديمقراطية؟ Project Syndicate، 19 حزيران\يونيو 2019
[6] – الانتخابات التشريعية السورية 1954- ويكيبيديا
[7] – حزب الشعب (سوريا) – ويكيبيديا
[8] – الكتلة الوطنية (سوريا) – ويكيبيديا
[9] – حزب أحرار – الحزب الليبرالي السوري
[10] – ماذا يطرح الحزب السوري الليبرالي الديمقراطي للسوريين؟ حرية برس Horrya press، 15 آب\أغسطس 2020
[11] -تقرير: تعداد المسلمين بفرنسا قد يصل إلى 13.2 مليون شخص بحلول عام 2025، RT Arabic، نقلًا عن وكالة تاس، 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017.
[12] – أولريش شيفر، انهيار الرأسمالية، د.عدنان عباس علي (مترجمًا)، سلسلة عالم المعرفة –العدد 371، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، كانون الثاني/ يناير-2010، ص 40.
[13] – المرجع السابق، ص 41.
[14] – المرجع السابق، ص 37-40.
[15] -ملخص للفكر الاقتصادي الكينيزي، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر.
مركز حرمون